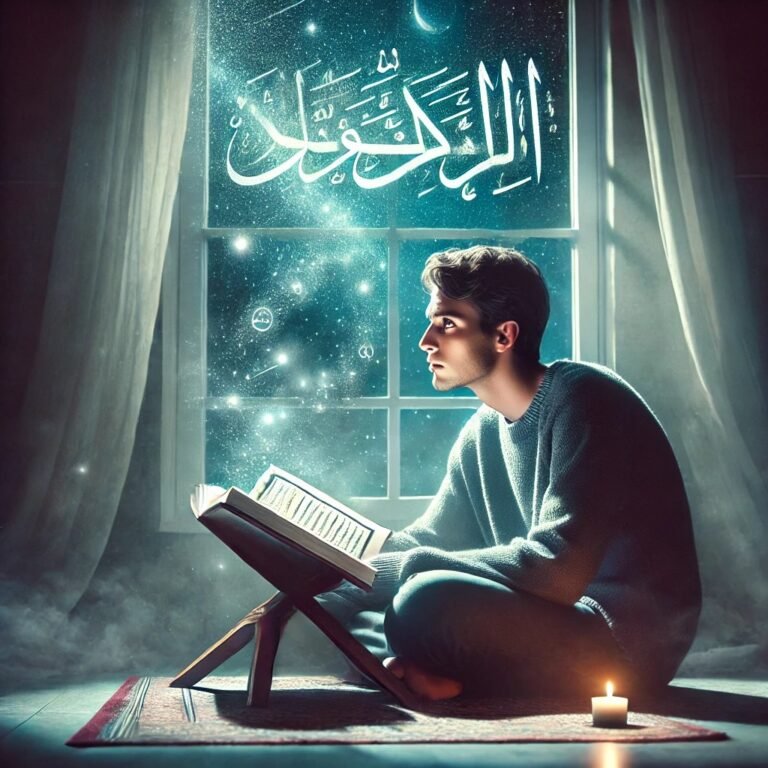من الظواهر التي تدعو للتأمل في حياة كثير من المسلمين، تلك المفارقة الغريبة التي نراها بوضوح: تجدهم يواظبون على تلاوة القرآن الكريم، بل إن من بينهم من يحفظه عن ظهر قلب، ومع ذلك لا ينعكس هذا القُرب من كلام الله على سلوكهم اليومي، أو أخلاقهم، أو حتى نظرتهم للحياة من حولهم. هذا التباين الملفت بين كثرة التلاوة وضعف الأثر لا يمكن تجاهله؛ إذ يفرض تساؤلًا عميقًا في الوجدان والعقل معًا: إذا كان القرآن كتاب هداية وتحوّل، فلماذا لا يبدو هذا التحوّل جليًا في واقعنا، رغم حضور التلاوة الدائم في حياتنا؟
هذا الطرح لا يقتصر على الفرد وحده، بل يلامس حال المجتمعات الإسلامية عمومًا، تلك التي تُعاني من اختلالات أخلاقية، اجتماعية، وسياسية، على الرغم من كثرة تلاوة القرآن وانتشاره في البيوت والمساجد. فلو تأملنا الواقع، نجد أن نسب الطلاق والتفكك الأسري تتصاعد في كثير من الدول الإسلامية، وتنتشر ظواهر مقلقة مثل الكذب والرشوة والنفاق، بينما تغيب القيم الحقيقية في تفاصيل الحياة اليومية. ترى الشخص يحفظ آيات القرآن أو يداوم على تلاوته، لكنه يغش في السوق، ويتقاعس في عمله، ويتجاهل القوانين في الشارع. فهل المشكلة تكمن في نص القرآن ذاته؟ أم في تعاملنا معه؟ أم أن هناك عوامل أخرى تُضعف من أثره في النفوس؟ للإجابة على هذه الأسئلة، سنعرض أولًا بعض المواقف التي تحاول تفسير هذه الظاهرة، ثم نناقشها من زاوية نقدية، ونختم بمحاولة شاملة تربط بين الأسباب والحلول.
من أسباب الضياع :
قلة الإيمان وغياب التأمل
يرى عدد من العلماء والدعاة، كـ الشيخ محمد الغزالي والدكتور عمرو خالد والدكتور طارق السويدان، أن أحد أبرز أسباب غياب تأثير القرآن في النفوس يعود إلى ضعف التدبّر الحقيقي لما نسمعه أو نقرؤه. فالقرآن لم يُنزَّل لمجرد التلاوة، بل ليُفهم بعمق ويوقظ العقل والقلب معًا، كما ورد في قوله تعالى: “كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ” (ص: 29).
في علم الأعصاب، أثبتت الأبحاث الحديثة أن الدماغ لا يتفاعل بفعالية حقيقية إلا مع المعلومات التي يتم معالجتها بوعي وتأمّل. المرور السطحي لا يكفي لتحفيز تلك المناطق العميقة المسؤولة عن الفهم والتخزين طويل الأمد واتخاذ القرار، خصوصًا الفص الجبهي (Prefrontal Cortex)، الذي يرتبط بالتفكير المنطقي والتأمل الذاتي. ولهذا، فإن التلاوة المجردة، التي تخلو من التدبّر، لا تترك في النفس أثرًا حقيقيًا. بمرور الوقت، قد تتحوّل إلى عادة صوتية متكررة، لا توقظ العقل ولا تمس القلب. أما حين يتدبّر الإنسان ما يقرأ، تنشط تلك الدوائر العصبية وتبدأ ملامح التحوّل الفعلي بالظهور.
وهذا ما تؤكده سير السلف الصالح. فمثلًا، عمر بن الخطاب تغيّر قلبه من مجرد سماع آيات من سورة طه، وكثير من الصحابة كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلّموها ويعملوا بها. فالمسألة، كما يراها هذا الطرح، ليست في القرآن ذاته، بل في طريقة التفاعل معه؛ حين تتحوّل التلاوة إلى عادة خالية من الوعي، يضيع جوهر الرسالة.
ابتعاد الدين عن واقع الناس
يرى بعض المفكرين، كمحمد شحرور وحسن حنفي، أن العلّة الأساسية لا تكمن في النص القرآني نفسه، بل في الفجوة السحيقة بين القيم التي يطرحها القرآن والواقع الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية. فهم يعتبرون أن البُنى السياسية والاجتماعية القائمة لا تُجسّد مبادئ مثل الحرية والعدل والشورى، بل تُفرغها من مضمونها شيئًا فشيئًا، حتى تصبح التلاوة أقرب إلى طقسٍ شكلي، يؤديه الناس كمن يردد أنشودة قديمة لا يسمع صداها في يومياتهم.
ولتقريب الصورة أكثر، تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق، رغم كونه بلدًا ذا غالبية مسلمة وتغلب عليه مظاهر التدين، يُعد من بين أكثر الدول فسادًا إداريًا وماليًا في العالم العربي. هذا التناقض الصارخ يُشبه من يرفع شعار النزاهة على جدار متهالك، بينما الأرض من تحته تميد بالفساد. وبينما ينصّ القرآن على الأمانة ومكافحة الفساد كقيم أساسية، تبدو هذه المبادئ في الواقع المعيشي كزهورٍ نبتت في صحراء، لا تجد تربة تحتضنها، مما يُضعف تأثيرها ويجعلها حبيسة النص، بعيدة عن أن تُترجم إلى ممارسة أو وعي جماعي ملموس.
التكيّف والاعتياد
في علم النفس، يشير بعض الباحثين إلى أن غياب التأثر بالقرآن قد يُعزى إلى ما يُعرف بظاهرة “التكيّف الإدراكي”، وهي حالة يعتاد فيها الدماغ على المحفزات المتكررة، فيتضاءل وقعها تدريجيًا. فالمرء، حين يتكرر على سمعه صوتٌ ما دون أن يصاحبه حضورٌ ذهني أو تجاوبٌ وجداني، يبدأ بالتعامل معه كصوتٍ مألوف لا يلفت الانتباه. ولعل هذا ما يحدث مع القرآن حين يُتلى باستمرار في البيوت أو المساجد أو عبر الإذاعات؛ فكثرة التكرار من غير تدبر تجعل الأذن تلتقط، لكن العقل لا يتفاعل، والقلب لا يرتجف، فتغدو آيات الوحي مألوفة النغمة، غائبة التأثير، بعدما كانت رسائل توقظ الضمير وتحرك الإيمان في الأعماق.
هل التدبّر كافٍ؟
رغم أن القول بأن التدبّر في القرآن أمر ضروري لا غبار عليه، إلا أن البعض يرى أنه لا يكفي وحده للوصول إلى التغيير الحقيقي. فكثير من الناس يُقبلون على التدبّر، يقرؤون ويحاولون فهم المعاني، ومع ذلك لا يشعرون بفرق جوهري في حياتهم اليومية. وهذا يُثير تساؤلات حول عوامل أخرى قد تكون أكثر تأثيرًا، مثل التربية التي نشأ عليها الإنسان، أو البيئة التي يعيش فيها، وحتى الضغوط النفسية والمادية التي تحاصره من كل جانب.
لكن الأخطر من كل هذه العوامل ما لا يُرى ولا يُلمَس، ذلك العدو الخفي: وساوس الشيطان. فهذا العدو لا يتوقف عن بثّ التشويش في القلب، ولا يملّ من صرف الانتباه عن المعاني العميقة. بل قد يُلبّس على المتدبّر نفسه، فيقنعه أن لا جدوى من كل هذا، أو يدفعه لأن يقرأ بلا وعي حقيقي، وكأنما يمضي في الكلمات دون أن ينفذ إلى لبّها.
وهكذا يصبح فهم القرآن لا مجرد مواجهة لتحديات الحياة ومشاغلها، بل معركة داخلية مع عدو خفيّ، عنيد، لا يريد للإنسان أن يجد الطريق إلى الهداية.
أين دور الفرد؟
صحيح أن الواقع السياسي والاجتماعي له تأثير بالغ على تشكيل فكر الإنسان وسلوكه، وقد يُشكّل في كثير من الأحيان حاجزًا صلبًا أمام أي محاولة للتغيير أو الإصلاح. لكن، هل من المنطقي أن نظل نُحمّل البيئة وحدها مسؤولية تعثّرنا؟ الإنسان، في حقيقته، كائن يمتلك إرادة، وإن ضعفت، فهي لا تختفي تمامًا، بل تنتظر لحظة إشراق، عزيمة صادقة، ورؤية تتخطى العوائق.
نحن لا نتحدث عن خيال؛ فالتاريخ حافل بنماذج لأشخاص تحدّوا المستحيل. خذ مثلًا بلال بن رباح، الذي وُلد عبدًا في مكة، لكنّه حرّر روحه حين آمن بقيمة الحرية التي جاء بها الإسلام، رغم كل ما ذاقه من ألم على يد أسياد قريش. أو الإمام أحمد بن حنبل، الذي نشأ في بغداد، وصمد في وجه طغيان السلطة العباسية وقت محنة خلق القرآن، متمسّكًا بقناعته رغم السجن والتعذيب.
نعم، المجتمع والسياسة يضغطان، لكن لا يُلغيان مسؤولية الفرد في أن يقول “لا”، أو في أن يبدأ التغيير من داخله، خصوصًا إذا امتلك بوصلة واضحة كالقرآن، الذي لا يُخلف من اتبعه في التيه.
هل الاعتياد حجة؟
الاعتياد قد يُضعف التأثر، لكنه لا يُسقط عنّا مسؤوليتنا تجاه ما نسمع أو نقرأ. لو كان الاعتياد عذرًا، لَما خشع الصحابة وهم يسمعون القرآن مرارًا. الفارق أنهم تلقّوه بقلوب حيّة، كأنهم يسمعونه أول مرة، بينما نحن نمرّ عليه كأنه نصّ محفوظ.
لماذا لا نتأثر؟ وكيف نتغير؟
بعد عرض هذه المشاهد، يتبيّن لنا أن جوهر المشكلة لا يكمن في القرآن ذاته، بل في الكيفية التي نتفاعل بها معه، وفي الظروف التي تحيط بنا، وفي مدى صدق نوايانا وإرادتنا. ويمكن تلخيص أبرز الأسباب والحلول في النقاط التالية:
الانفصال بين القيم والواقع
رغم فساد بعض مظاهر المجتمع، إلا أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، من الفرد ذاته. يمكن لأي شخص أن يشق لنفسه طريقًا نقيًّا، ويُنشئ بيئة صغيرة تحمل روح القرآن—تبدأ من البيت. حين يصبح القرآن مرآة لسلوكنا اليومي، ومنبعًا نستلهم منه في أخلاقنا وقراراتنا، يتحوّل البيت إلى مساحة مشبعة بالنور الداخلي. يصبح الحوار بين الزوجين أقرب للرحمة، وتربية الأطفال قائمة على التوازن والحكمة، والتعاملات الاجتماعية محكومة بقيم الصبر، والصدق، والعفو. حتى الأصدقاء والمحيطون يمكن أن يُشاركونا هذا الجو الروحي من خلال لقاءات بسيطة، تدبرات قرآنية متبادلة، أو حتى مبادرات تطوعية تُستوحى من تعاليم القرآن. بهذه الخطوات المتواضعة، يصبح للقرآن مكان في تفاصيل الحياة اليومية، وتتحول البيوت إلى محطات هداية.
الاعتياد والجمود الروحي
كثيرًا ما نقرأ القرآن دون أن يتحرك فينا شيء، والسبب أننا نعتاد، ونفقد ذلك الشعور الأول الذي كان يهزّ القلوب. لهذا نحتاج إلى تجديد النية باستمرار، وإلى أن نقرأ القرآن كما لو أنه يُخاطبنا الآن، في هذه اللحظة. نحتاج لقلوب حاضرة، وعقول منفتحة، تحاول أن تعيش كل كلمة، وكأننا نسمعها لأول مرة. الدعاء هنا ضروري، لأنه يفتح المغاليق ويليّن القلوب. نقول: “اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً”. فهذا التوفيق لا يُنال إلا برحمة من الله، وعلينا أن نلحّ في الدعاء بأن يجعل القرآن نورًا لصدورنا، وشفاءً لهمومنا، وراحة لقلوبنا التي أثقلها الركض وراء الدنيا.
غياب الفهم والتدبر
كثيرون يقرؤون، ولكن قليل من يتدبر. قراءة بلا تدبر كمن يشرب ماءً لا يروي. لا يكفي أن نمرّ على الآيات مرور الكرام؛ يجب أن نتأنى، ونرجع للتفاسير الموثوقة، ونحاول أن نفهم الرسائل العميقة خلف كل كلمة. وعندما نقرأ آية تلامس واقعنا أو تعالج سلوكًا نعيشه، نتوقف ونتساءل: هل أعيش هذه الآية؟ هل أنا من الذين يعملون بها؟ بعدها نرسم خطة صغيرة للتطبيق: عادة نتركها، أو خلق نغرسه في يومياتنا. بهذه الطريقة، يتحول القرآن من كتاب نقرؤه فحسب، إلى رفيق نُصلح به أنفسنا ونغيّر من حولنا.
الإلهاءات الحديثة
نعيش في عالم مزدحم، مليء بالضوضاء الرقمية. الهواتف، الإشعارات، الفيديوهات، المنشورات… كل شيء ينافس وقتنا وانتباهنا، حتى صارت لحظات الخشوع نادرة. لذلك، نحتاج إلى عزلة يومية مع القرآن، وقت لا يُزاحمه أي شيء آخر. الصباح الباكر مثلًا، أو الليل حين يهدأ كل شيء—هذه اللحظات ثمينة. نطفئ الأجهزة، نغلق الأبواب، ونجلس مع كلام الله بخشوع. قد يوسوس لنا الشيطان ويشغلنا بهموم لا تنتهي، لكن بنيّة صادقة، وقلب يعرف قيمة هذه اللحظات، يمكننا أن نحفظ على أنفسنا هذه المساحة من الطمأنينة. فحين نعطي القرآن من وقتنا بصدق، يُعطينا هو ما لا يُعطيه أي شيء آخر: الطمأنينة، والبصيرة، وهدوء القلب.
إذًا، ليست المشكلة في القرآن نفسه، بل في الطريقة التي نتعامل بها معه. فالقرآن كتاب يحمل طاقة التغيير، لكنه لا يُثمر إلا إذا وجَد قارئًا مستعدًا لأن يتغيّر. كثيرون يقرأونه فقط ليرتاح ضميرهم، أو يطلبون بركته دون أن يفتحوا قلوبهم لما بين سطوره. وهناك من يعيش في بيئة لا تشجعه على أن يُطبّق ما يقرأه.
ومع ذلك، يخبرنا التاريخ أن القرآن لا يزال حيًا قادرًا على إحداث التغيير، بشرط أن يُقرأ بقلب واعٍ، كأن الآيات تُخاطب قارئها مباشرة. فليس التحدي في عدد مرات التلاوة، بل في مدى التأثر بها، وصدق التفاعل مع كلام الله. فهل نحن فعلاً على استعداد لنعيش هذا التحوّل؟